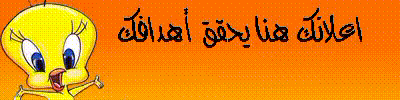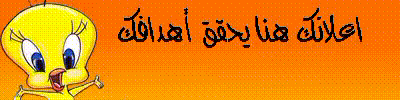في تعريفه للدين ، يقول محمد الطاهري بن أشور: “الدين: الاعتقاد والدين ، وهو المعلومات والمعتقدات التي يعتقد المرء ، لذلك يتم إجراء أفعاله على متطلباته ، لذلك كان يطلق عليه دينًا ، لأن أصل معنى الدين هو العلاج والمكافأة”.
ومع ذلك ، فإن العديد من النخبة لا تفصل بين الدين مع ما هي المذهب والأحكام والقوانين ، والتعبيرات الدينية للأشخاص ، والتي تعتبر تعبيرات تتعلق بمدى فهمهم لهذا الاعتقاد ومدى قرارهم على القوانين من هذه القوانين ، وأيضًا مدى قدرتهم العقلية على تفسير النص الديني بطريقة تجعل آثارها قادرة على معالجة وقتهم وتوضيحها إلى القوانين المدنية ؛ سيكونون منافسين للدول المتقدمة الأخرى وليسوا في وضع التخلف والاعتماد الذي يهين أنفسهم وإهانة معتقداتهم.
تلك النخبة ، سواء كانت تنتمي إلى حضارات أخرى أو تنتمي إلى حضارتنا الإسلامية ، تثير سؤالًا حول ما إذا كان الإسلام هو سبب التراجع عن المسلمين ، ويشير مباشرة إلى أن الليبرالية أو العلمانية في الشرق والغرب كانت قادرة على تحقيق تفوقها الحضاري في مختلف المجالات دون أن يرتبطوا بكنائسها ومواجهاتها ، وهم يوفرون أي إجهاض. الحضارة.
هذا السؤال ليس جديدًا. بدلاً من ذلك ، إنه سؤال تم استرداده أن الأزمات والصدمات الحضرية لدعوة العالم الإسلامي.
تسببت حملة نابليون ضد مصر في عام 1798 ، في صدمة في الوعي العربي -الإسلامي ، وهو أول غزو للشرق الأوسط منذ الحروب الصليبية الثمانية التي امتدت من 1095 إلى 1291 ، كانت الحملة من أجل الأسباب السياسية والعسكرية والاقتصادية فقط في سياق منافسة إنجلترا للشرق الأوسط ، وخاصةً في الضعف في العجول المقل على مستوى علوم التكنولوجيا والفنون والأدب ، وحتى على مستوى صورة النساء الفرنجيات في علاقتها مع الرجال وفي دورها على أنها واعية وفعالة وكفاءة ومعروفة.
أنتجت هذه الصدمة سؤالًا مباشرًا في ذلك اليوم: لماذا تقدم الغرب والمسلمين؟
كانت الإجابة على ثلاث مدارس في فكرة الإصلاحيين: موقف لا يرى نداءً متحضراً للمسلمين إلا من خلال العودة إلى سيرة آل ساليه ، ونحن نقلدهم ونقلدهم ، والموقف المتناقض لا يراها ما يتماشى مع العصر ، باستثناء تقليد الغرب ومتنافسيها في “الحلوة والمرارة”. القطع الأثرية والفنون.
بعد أكثر من قرنين وربع ، ما زال العرب والمسلمون يقيمون في نفس الترتيب المتحضر ، وما زالوا يتعرضون لحملات الغزو الحقيقية كما حدث في أفغانستان والعراق ، ولا يزال قضية فلسطين من الجروح ويحدثونهم ، ويعملون على التبعية ، ويتم تفعيلهم ؛ على الرغم من وفرة عددهم ، وعلى الرغم من الموقع الجغرافي الذي باركه الله والثروة الطبيعية.
على الرغم من ما جذبت المقاومة في طوفان AL -AQSA من صورة مذهلة للشخص المسلمي العربي عندما يعتمد على نفسه ؛ إنه مبدع في مواجهة أعداء الحياة ويخلق ترجمة أخلاقية لإيمانه ويخلق إهمال العدو بكرامة ومبدأ وكفاءة ، لأن المشهد العام في عالمنا الإسلامي والعرب على وجه الخصوص هو مشهد لا يساعدنا في التصنيف الكامل على التصنيف الكامل من أي شيء في التصنيف الكامل. التخلف عننا ، خاصة منذ إنشاء الدول القطرية ، بعنوان “الدولة الوطنية”.
نحن المسلمون نقدم محاضرات حول جماعة الإخوان المسلمين في الإسلام ، عن العدالة ، حول الحرية ، وعن المساواة ، حول العلم ، القوة ، الكبرياء ، والرحمة ، لكننا نمارس الظلم والطغيان والنهب ، ونكشف عن مستوى عالٍ من التعصب والوقاحة والكراهية ، ونحن نمارس مواطننا على قوى العموديات الاستعمارية ؛ إذا قتلنا بعضنا ونمارس الإساءة والتعذيب لتقديم حجة لأعدائنا عندما يقولون إن المسلمين أكثر وحشية من الصهاينة ، وأنهم لا يستحقون الديمقراطية أو الحرية ، وأنهم لا يمكن أن يكونوا شركاء في بناء حضارة إنسانية حتى إذا كرروا ما جاء في قرآنهم: “لقد كنت أفضل أمة تخرج من الناس إلى أنفسهم بشكل جيد والمعتقدين من الله”.
المسلمون اليوم ، عندما صنعوا أزمة الحضارة ، أهانوا أنفسهم ، وضللوا الإسلام عندما جعلوا رأيًا عالميًا واسعًا يتساءلون عن جدية القول بأن الإسلام هو منقذ الإنسانية وأن رسوله هو رحمة للعوالم.
تعد المسؤولية الأخلاقية والتاريخية والقانونية كبيرة جدًا بالنسبة للعلماء المسلمين ونخبهم وقادتهم ، لذلك إذا لم نتمكن من المساهمة في الثورة العلمية ، فلماذا لا يمكننا الاستفادة من هذه الثورة أن ننسى في ثورة في المعرفة الإنسانية في امتثال لبعض خصائص “أفضل الأمة” وهي “تطلب الفضيلة والشرط”.
إنه بالنسبة لنا ، وقمنا بتحويل جغرافيا أوطاننا ، لأننا حولنا مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إلى “بؤر” حقيقية ، وليس افتراضية ؛ نذهب إلى معارك مميتة ، ويتداول العالم مشاهد لممارساتنا البدائية والوحشية ، ومشاهدنا من بؤسنا ، فقرنا ، وخراب عمراننا.