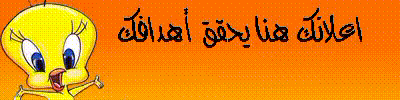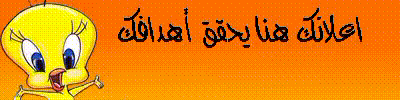خرج جو بايدن من المبارزة مع دونالد ترامب جريحاً؛ خانه العمر، وهذا ما اعتاد عليه. خيانة في لحظة الذروة وأمام عشرات الملايين الملتصقين بالشاشات. فشل بايدن في لعب دور الهداف ودور المدافع وإظهار كفاءة حارس المرمى. الأضواء تحول النكسة إلى كارثة. الرأي العام صارم وحاقد، وانطباع واحد يكفي لقلب صفحة رجل، أياً كان. لا تهاون ولا رحمة. وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالناس القساة والمفترين والذئاب. لا شيء يساعد الضعيف في هذا العالم، خاصة إذا كان يطالب بتمديد إقامته في البيت الأبيض. لا يمكن تسليم مفاتيح العالم وقيادة الأسطول لرجل لا يستطيع تذكر ذاكرته.
بدا بايدن وكأنه حصان تعرض لأضرار بالغة قبل اللفة الأخيرة. نصحته صحيفة نيويورك تايمز بالانسحاب من السباق. وهذه النصيحة ليست بسيطة على الإطلاق، وقد أعقبتها نصيحة من نفس القماش. ولم يخف أعضاء الحزب الديمقراطي اعتقادهم بضرورة استبداله لتجنب هزيمة مؤكدة. واستبداله في هذه المرحلة من السباق ليس بالأمر السهل. والعملية بحد ذاتها معقدة، خاصة إذا أصر على مواصلة الرحلة. لكن خيار الاستبدال ليس مستحيلا، خاصة إذا نشأ الانطباع بأنه الخيار الوحيد لإبعاد كأس ترامب عن شفاه أميركا والعالم. ويراهن كثيرون على أن السيدة جيل بايدن زوجة الرئيس ستتولى مهمة إنقاذه وربما إنقاذ الحزب والبلاد من فوز ملاكم مثير للقلق اسمه ترامب. ويراهن آخرون على أن باراك أوباما سيشجع بايدن على شرب الكأس.
كم هو صعب إقناع سياسي مدمن بالتقاعد! وكأنك تطلب منه أن يبلع الهزيمة تحت أوراق الشيخوخة. وتزداد الصعوبة عندما يكون الرجل قد أمضى عقوداً في مؤسسات ومناصب توّجت بالرئاسة، واعتاد الإقامة في القصر برفقة الأختام. كم هو قاسٍ أن يعترف السياسي بأن دوره انتهى، وأن وقته ينفد! السلطة أم الأعياد، لا يستطيع التخلي عنها إلا الزاهد «المريض». أذكر أنني ذهبت ذات يوم لزيارة سياسي حكيم كان يدشن رحلة وهو في الثمانينيات من عمره. قلت له: «سعادة الرئيس، ليس من حقك أن تخفي تجربتك الغنية عن متناول القراء». فقال: «الوقت غير مناسب». جددت الطلب، فرد قائلاً: «أوافق، وسنعقد عدة جلسات». سألته أين؟ فأجاب: «في القصر الرئاسي». صعقتني الإجابة، وعرفت أن طريق القصر مليء بالفخاخ، ومعرض للانعطافات والالتواءات. فشممت رائحة “لعنة القصر” في كلماته.
والنقاش الذي تابعه العالم غريب، لأن نتائجه تؤثر على أمنه واستقراره وازدهاره. وفي عصر الثورات التكنولوجية المتعاقبة والذكاء الاصطناعي، لم تتمكن أمريكا من دفع شاب أو شبه شاب إلى سباق البيت الأبيض! ولا يعد هذا النقاش الأميركيين إلا بتعميق الانقسامات. إنه لا يعد العالم بشيء سوى المزيد من الاضطرابات في الغابة الدولية. ولا أحد ينصح أميركا بالبحث عن شخص مثل ريشي سوناك، الذي يقود حزب المحافظين إلى نوع من التقاعد في غضون أيام قليلة. ولا ماكرون، الذي أهدر بمبادراته وارتجالاته هيبة جمهورية ديغول وميتران وشيراك. ولا شخص مثل الرجل الجالس في مكتب ميركل.
هناك من يعتقد أن صحة الغرب تشبه صحة بايدن، وأنه لم يعد قادرا على إدارة العالم، وأنه يرفض الاعتراف بالواقع الاقتصادي والعسكري والسياسي الجديد، وأن مهمة أي رئيس أميركي جديد ستكون أصعب من ذي قبل، فروسيا تغيرت، والصين وأوروبا، إضافة إلى القوى الإقليمية التي ترى دورها في التسلل إلى خرائط جيرانها.
في نهاية المناظرة وجد العالم نفسه أمام واقع صعب وربما مكلف، فقد بدا ترامب وكأنه قدر أميركي ودولي يصعب الإفلات منه، فليس من السهل على ساكن البيت الأبيض أن يكون رجلاً يصعب التنبؤ بتوجهاته، ويصعب النوم على وسادته، وهذا أمر مقلق للأعداء والحلفاء على حد سواء، فترامب ليس ابن المؤسسات كما هي الحال مع بايدن.
لقد اكتشف العالم أن الأميركيين قد يرمون بحجر كبير في البحيرة الدولية المضطربة على نحو متزايد في الانتخابات المقبلة. ويشمل القلق حكام أوروبا وجنرالات الناتو وزيلينسكي. فهل يجبر ترامب الرئيس الأوكراني على الذهاب إلى مفاوضات سلام مع فلاديمير بوتن الذي لا يستطيع العودة خاسرا من رحلته الأوكرانية؟ إن استرضاء القيصر بقطعة من جسد أوكرانيا يدفع الأوروبيين إلى التحذير من تكرار عملية استرضاء هتلر، على الرغم من عدم وجود تشابه بين الرجلين والمرحلتين. إن شعور ترامب بأنه رجل “الصفقة” لا يطمئن القارة العجوز التي اكتشفت أن قدسية حدودها الدولية سقطت على التراب الأوكراني.
وتؤكد تصريحات ترامب أنه لا يشم رائحة ما يسميه الأوروبيون “التهديد الروسي”. ويعتقد ترامب أن الخطر الحقيقي على أميركا يأتي من «مصنع العالم»، أي من الصين. هل يستطيع العالم أن يتسامح مع السياسات الأميركية القائمة على عرقلة الصادرات الصينية، وهل ستدفع هذه السياسة بكين إلى الدخول في تحالف بلا حدود مع روسيا، معلناً رسمياً العودة إلى عالم المعسكرين؟ فهل تتمكن أوروبا، التي تشعر بالقلق إزاء روسيا وصعود اليمين المتطرف، من تحمل أعباء عالم من هذا النوع؟
ماذا عن الشرق الأوسط الذي يغلي بالمذبحة العلنية في غزة، واحتمال انتقال الحرب إلى الجبهة اللبنانية؟ ماذا عن “الدولة الفلسطينية” التي قد تشكل المخرج الوحيد لضمان عدم تكرار “الطوفان” والحروب المرافقة له؟ وماذا عن الخلاف النووي مع إيران، التي قد يجد مسؤولوها صعوبة في إبرام أي اتفاق مع الرجل الذي أمر بقتل قاسم سليماني؟
وكان النقاش مثيرا. ترامب يتقدم، يرجى ربط الأحزمة.
(لندن الشرق الأوسط)